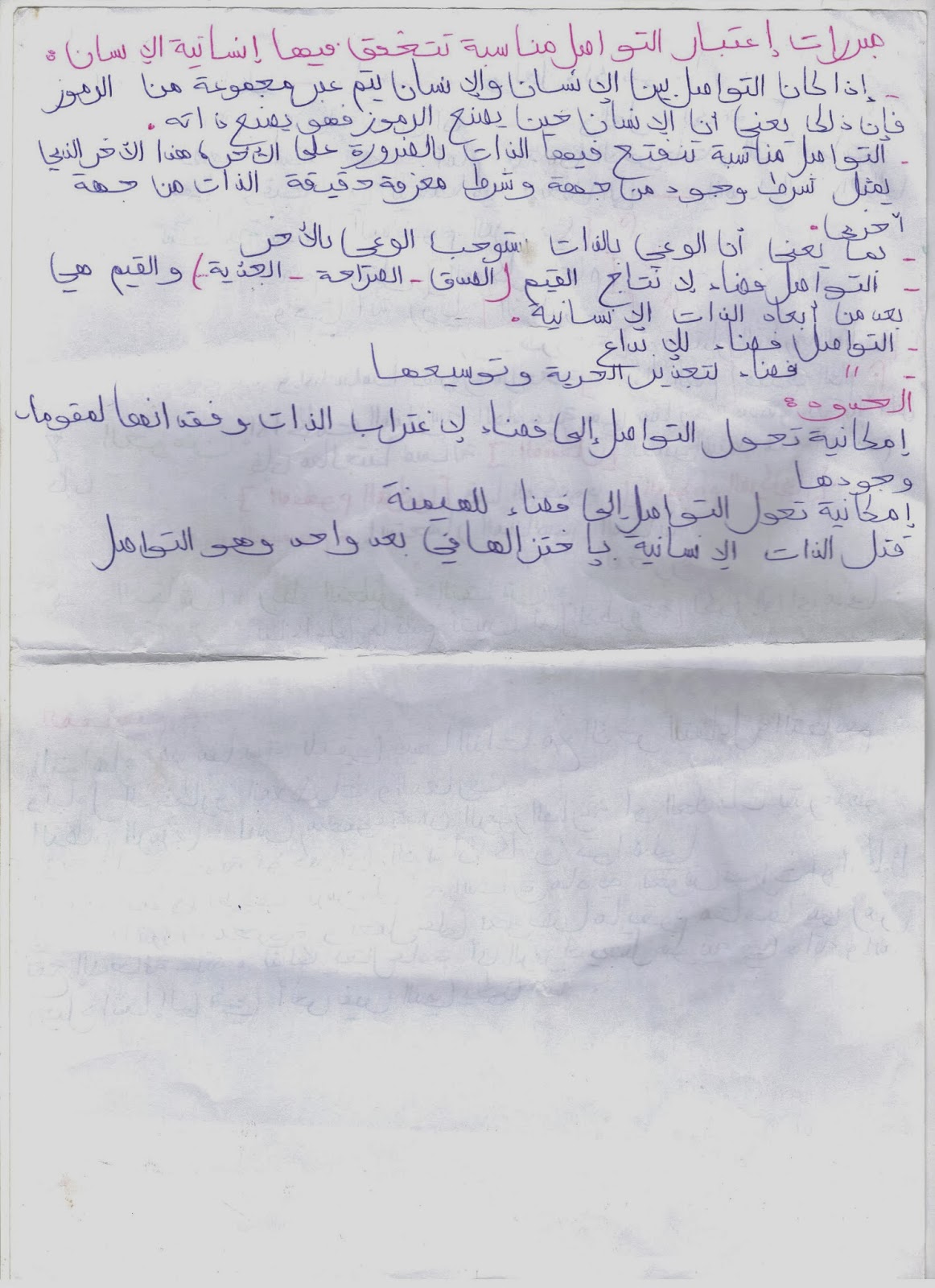ملاحظة قبل البدئ: هذه مجموعة من التلاخيص و الافكار لتوضيح و تبسيط محور الفن يجب عدم نقلها كما هي من المدونة و نسخها في الفرض
الفن :الجمال والحقيقة
تمهيد:
يسود الاعتقاد اليوم بأن الفن هو وسيلة للهروب من الواقع، اعتقاد سائد إلى درجة أن أكثر الناس اليوم لا يميزون بين منتوجات المجتمع الاستهلاكي التي لها أهداف ترفيهية و الإبداعات الفنية التي تتضمن من جهة مبدعها مثلما من جهة المهتمين بالشأن الفني، استثمارا حقيقيا قد يصل إلى حد الوجد. فنحن نرى في الفن نوعا من الوسيلة التي تهب لنا انتشاءات متنوعة و مختلفة، انتشاءات موسيقية و سينيمائية و مسرحية... تتمثل وظيفتها في التسلية إذ تساعدنا على نسيان الواقع الباهت و الفظ الذي نعيش فيه.
غير أن هذا الضرب من التعامل مع الفن مبني على نسيان المجهودات، ربما، الفوق إنسانية التي يقوم بها الفنان ليشنع و يتجاوز و يتعالى و يجمّل الواقع ذاته. هو أيضا نسيان يحمل الفن بمقتضاه رسالة. وفي هذا المعني ما غنم الإنسان الذي يصارع ضد خزي الواقع، و ضد حماقات المجتمع، بل و ضد حماقات الإنسانية بأغاني و بموسيقى و بصور و نحوت، إذا كان هدف الفن هو الهروب من الواقع؟ فما الفن، إذن، و أي صلة تربطه بالواقع؟ هل أنه مبدع للجمال من أجل الارتحال عن الواقع؟ أم أنه يؤسس حقيقة متعالية على ما هو محسوس بشكل مباشر فيستدعينا إلى عالم الجمال الذي يوقظ فينا خزي الواقع وقبحه، فلا يكون الارتحال عن الواقع إلا لغزوه من جديد؟ أم أن الجمال و الحقيقة لا يلتقيان إلا ليتناقضا؟ أليست الحقيقة متضمنة للفرح و بالتالي لبهاء الجمال الروحي؟
Iالفن و الجمال
إن لكلمة فن معنيان:
ـ ففي المعنى الأصلي للكلمة يعني الفن مجموعة الطرق التي تمكننا من الحصول على نتيجة ما وفي هذا المعنى نتحدث عن فن الصناعة :فن الطبخ...و الفن بهذا المعنى يتعارض مع العلم باعتباره معرفة نظرية إذ يعني الفن هنا تقنية , وهذا المعنى هو الذي يعطيه أرسطو للفن إذ يعتبر أن الفنان حرفي .
ـ كما يعني الفن خلق أشياء جميلة يقول لالوند " الفن أو الفنون تعني كل إنتاج للجمال بآثار كائن واعي" و في هذا التحديد نتبين علاقة وثيقة بين الفن والجمال. ذلك أن الجمال هو المفهوم المعياري والأساسي الذي تحيل إليه الأحكام الجمالية.
و أن نقول حول شخص ما أو شيء ما أو حتى فكرة ما, إنّه جميل, هو أن نعترف له بخاصّية نحكم إنها ايجابية: خاصية الجمال. و لكن هذه الخاصّية أو بالأحرى هذه الصفة ليست من باب المعرفة العلمية, فلا نستطيع أن نقر جمال شيء ما بقوانين الفيزياء أو قوانين الرياضيات وحدها. كما أن الجمال ليس من باب الأخلاق أيضا, فالرجل الجميل ليس بالضرورة الرجل الفاضل، ليس هو من باب ما هو عملي, فالشيء الجميل ليس بالضرورة صالحا لشيء ما. و في كلمة إن الجمال ينتمي إلى حقل الإستيتيقا في المعنى الكانطي, أي أن الفرد وحده قادر على أن يحكم على جمالية الأشياء انطلاقا من إحساساته. ومن هذا المنطلق فان التفكير حول الجمال يطرح صعوبات خاصة، وأن الأمر لا يتعلّق فقط بكون كل فرد يمكن أن يعتبر جميلة أشياء مختلفة جدا، بل أن كل الناس أيضا لا يتفقون حول جمالية الأشياء.
و يجب أن نلاحظ أن اختلاف الأحاسيس بين الناس ليس العامل الوحيد الذي يحول دون تقديم تعريف موحد للجمال لأنه لو كان الأمر كذلك لقلنا ببساطة بأن الجمال يتحدد بطريقة ذاتية، و أن الجميل بالنسبة لشخص ما، هو ما يولد لديه إحساسا بالجمال. غير أن الأمر ليس على هذا القدر من البساطة.
وقد نعرف الجمال بأنه ما يعجب من زاوية إستيتيقية، ولكن هناك طرق إعجاب مختلفة، فنفس الشخص يمكن أن يحكم في ذات الوقت بجمال امرأة حسناء وقدر قد بدقة. غير انه لا يعيش نفس الإحساسات أمام المرأة و أمام القدر.
كما يمكن أن نعتبر أنه يوجد شكل من الجمال يكون أرقى من بقية الأشكال الأخرى، ولكن الناس يختلفون بحسب الفترات التاريخية حول هذا الجمال الأرقى، فنحن نستطيع أن نقابل مثلا، وبطريقة مثالية بين التصور الكلاسيكي للجمال الذي يمجد الجمال المطلق الإلهي، والتصور الحديث الذي يعتبر أن الجمال العميق يوجد في الكون بل و ربما حتى في العجيب.
وهذا يعني أن تحديد الجمال يصطدم بثلاث صعوبات فهو غير مدرك بنفس الطريقة بحسب الموضوع الذي يرتبط به، وهو غير مدرك بنفس الطريقة لا بحسب حساسية الذات ولا بحسب مثالها الإستيتيقي.
يبدو إذن، انه ليس هناك معيار يمكننا من القول بيقين إن هذا الشيء أو ذاك جميل. و ربما يقتضي الأمر البحث عن تفسير إحساس الجمال بحسب تنظيم الذهن البشري.
ذلك ما ذهب إليه دافيد هيوم في القرن الثامن عشر عندما أقرّ : "إن الجمال ليس خاصية ملازمة للأشياء في حد ذاتها، فهو يوجد فقط في الذهن الذي يتأملها، وكل ذهن يدرك جمالا مغايرا". أكثر من ذلك، يرجع هيوم إحساس الجمال إلى إحساس اللذة: "إن اللذة والألم ليسا فقط المرافقين الضروريين للجمال والقبح، بل هما ماهيتهما".
لكن هذه المقاربة لا تؤدي بالضرورة إلى نسبية مطلقة، ذلك أن هيوم ذاته يستحضر التربية و وحدة الطبيعة البشرية ليبرر نوعا من الاتفاق الذي يبدو سائدا حول الأشياء الجميلة. وإذا لم يذهب هيوم بعيدا في موقفه هذا، فإن بعض البحوث العلمية اليوم أثبتت أن عوامل وراثية وجينية تتدخل في إنتاج إحساس الجمال.
و كانط نفى مثل هيوم، في "نقد ملكة الحكم" وجود قاعدة أو معيار للجمال. غير أنه يلاحظ أن الجمال ليس ضروريا بالنسبة للذة، و لا اللذة ضرورية بالنسبة للجمال. ثم إنه يضيف كون كل حكم جمالي ينطوي على طموح الكونية والموضوعية، فالجميل هو "ما يعجب كونيا دون مفهوم"، والجمال عنده هو "إحساس نزيه بالانشراح والحبور" عند استهلاك أثر ما. و يمكن أن نلخص النظرية الكانطية في الفن في النقاط التالية :
يميز كانط بين المستحبّ الذي يمكّننا من لذة حسية والجمال الذي لا يرتبط باللذة الحسية, فالجمال يرتبط بانشراح نزيه .
يحلل كانط بعد ذلك الكونية الجمالية التي هي كونية دون مفهوم، فعندما أحكم على شيء ما بكونه جميل فإني أنسب إلى كل الناس الإحساس الذي ينتابني أمام هذا الشيء, فهي، إذن، كونية بالحق لا بالحدث. ثم إن هذه الكونية ليست منطقية يقول كانط: « الجميل هو ما يعجب بطريقة كونية دون مفهوم».
في الحكم الذوقي يحصل تطابق بين الموضوع من جهة والخيال والفاهمة(ملكة إصدار الأحكام) من جهة أخرى، فالموضوع متناغم. لكن هذا التناغم لا يرتبط بغاية خارجة عن الفن بل أن غايته هي الفن ذاته أي الجميل.
الحكم الذوقي هو حكم ضروري وهذه الضرورة تنتج عن كونيّته لذلك فهي ضرورة ذاتية.
غير أن الجمال عند أفلاطون يرتبط بالحق (le vrai) والخير (le bien)، لذلك يميز بين الجمال في التجربة الحسية المباشرة باعتباره صفة نحملها على الكائنات والأشياء ويعتبره ظاهرا ليس إلا انعكاسا للجمال في ذاته أو مثال الجمال، بحيث لا تكون الأشياء المحسوسة جميلة إلا بمشاركتها في مثال الجمال، ذلك أن فكرة الجمال أرقى من الانشراح الذي تسببه الأشياء الجميلة المحسوسة. فأفلاطون يؤسس نظرية موضوعية حول الجمال، إذ يبين في "المأدبة" كيف يمكن أن نرتقي من الرغبة في الأجسام الجميلة إلى حب الأرواح الجميلة حتى ننتهي إلى تأمل الجمال في ذاته. وبهذا التدريب على الجمال في هذه المراحل الثلاث: التطهير والارتقاء والتأمل، يعطي أفلاطون شكلا جدليا لصعود الروح نحو الإلهي، وينجز بهذه الكيفية التقابل بين اللوغوس والأيروس. ولا يجب أن ننسى أن أفلاطون تماما مثل أرسطو من بعده يربط بين الجميل والمتناغم، رغم كون فكرة الجمال/الغاية تضاف عند أرسطو لفكرة الجمال/الكمال، فما هو جميل عند أرسطو ليس أمرا صدفويا، بل هو كذلك من أجل غاية ما. وهكذا فإذا كان أفلاطون يدين المحاكاة فإن أرسطو يقبلها بما أن الطبيعة، في نظره، تتصرف بالشكل الذي سيجعل الأشياء جميلة.
II الفن و الحقيقة
لا أحد ينكر أن الحقيقة جميلة بذاتها، إذ «يوجد الحق إلى جانب الجميل و الخير كما كان ذلك بديهيا في العالم القديم» على حد قول غادامر. ذلك أن حقيقة العبارة بما هي تعبير عقلاني عن معرفة الواقع، ضرورية بالنسبة للإنسان من حيث هو كائن عاقل. غير أن الحقيقة يمكن أن تجد أشكالا أخرى في التعابير الإنسانية فتكملها، خاصة عندما يتعلق الأمر بما لا يمكن قوله، عندما يتعلق الأمر بأعماق أعماق القلب. و الفن هو ضرب تعبير إنساني يتجاوز حدود الحاجة الحياتية الضرورية لكل كائن حي، إذ يمثل غزارة للثراء الإنساني الداخلي. فالفن هو ضرب من الحكمة العملية التي تمزج بين المعرفة والمهارة لتهب شكلا لحقيقة واقع في لغة الإحساس، لغة الرائي و المرئي، إذ «هناك حقيقة شهيق و زفير للوجود، هناك تنفس في الوجود، هناك فعل و انفعال لا يمكن بالكاد تمييزهما بحيث لا نعود نعرف من الذي يرى و من الذي يُرى» على حد عبارة موريس مارلوبونتي. و إذا كانت دراستنا للمسألة العلمية قد بينت لنا نسبية الحقيقة التي تتحدد بالنسبة لمنظورية الذات العارفة، فإننا لا نجانب الصواب إذا قلنا أنها غير بعيدة عن الرؤية الذاتية للفنان الذي يبدع في تمثلاته آثارا فنية، إن الفنان لينمذج الواقع بطريقته الخاصة.
1) الفن والمحاكاة
يرى أفلاطون أن الفن محاكاة للطبيعة فالمرجع الأول لكل الأشياء هو المثال, ومثال ذلك فكرة السرير التي يأخذها الحرفي كقانون لصناعة السرير ويخلق عندها السرير المحسوس والمادي , والفنان يحاكي هذا السرير المحسوس الذي حققه النجار, سرير هو ذاته نسخة. وهكذا تأتى المادة الفنية بالنسبة لأفلاطون في الصف الثالث من النظام الأنطولوجي فأولا الفكرة ثم الأشياء وأخيرا الإبداعات الفنية , ومن ثمة فإن الفن بالنسبة لأفلاطون وهم والجمال الفني ليس إلا شبحا للجمال الحقيقي.
لكن إذا كان أفلاطون قد حلل كما ينبغي الجمال الكوني فإنه لم يحسن التعبير عن هدف الفن. فالفنان ليس حرفيا ولا يصنع أوهاما محسوسة بل إنه يكشف الأثر الواقعي، لذلك يرى هيجل أن مبدأ المحاكاة لا يمكّننا من معرفة الطبيعة العميقة للفن, فلِما ننتج الطبيعة مرة ثانية إذا ما كان ما نتأمّله في حدائقنا أو منازلنا يكفينا، ثم إن الفن المحاكي لا يستطيع أن ينافس الطبيعة, يقول هيجل :« على الفن أن يبحث عن غاية أخرى عدى المحاكاة الصورية للطبيعة لأن المحاكاة في كل الحالات لا تنتج إلا آثارا تقنية لا آثار فنية». و Leonard De Vinci نقد أيضا التصور الأفلاطوني للفن عندما أقر بأن الفن هو إبداع ذاتي فالفنان رب خالق يبدع من ذاته لا عن مثال. غير أن الكاتب والروائي الإنجليزي أوسكار وايلد (1856ـ1900) يذهب إلى أبعد من هيجل و دي فنشي، إذ لا يكتفي بنفي المحاكاة, محاكاة الفن للطبيعة بل يرى عكس ذلك أن الطبيعة هي التي تحاكي الفن. فوارذار بطل قوات كان سببا مباشرا في انتحار العديد من الناس، ذلك أن أدبيات الفن تستبق الحياة والطبيعة, تنمذجها وتخلقها, و روني بطل شاتوبريون، وأنطوان رونكنتان بطل سارتر (وأبو هريرة بطل المسعدي) وأبطال آخرون يسكنون الأذهان ويشكلون الواقع, يقول وايلد «إن القرن التاسع عشر كما نعرفه هو بنسبة كبيرة من صنع بالزاك والطبيعة مثلها مثل الحياة تحاكي الفن , فم الطبيعة إذن؟ ليست الطبيعة الأم التي ولدتنا بل هي من إبداعنا» .
2) الجمال و التمثّل
عندما نقول إن اثر ما هو تمثل, فإن ذلك قد يعني إما أن الأثر هو انعكاس لنموذج طبيعي معطى, و إما انه نتيجة نشاط أصيل أو أسلوب نظر على حد عبارة مالرو الذي يقول "الفن هو ما به تصبح الأشكال أسلوب ".
في الحالة الأولى، التمثل هو مجرد صورة, ازدواج ظاهر ما, هو المحسوس المقدم مرة ثانية. والتمثل يكون عندها نتيجة تشويه مزدوج, الصورة كشكل محسوس لشيء ما و التمثل كرسم لذلك الشيء. و يكون التمثل بالتالي، ظاهر الظاهر دون أن تكون لدينا القدرة على تحديد درجة التشويه الذي يحمله في ذاته إذا لم يكن النموذج حاضرا لدينا. و كانط يستبعد هذا المعنى الأول الذي يجعل من الأثر رسما سيئا عندما اقر بان الفن ليس تمثل الأشياء الجميلة. فكانط يستبعد مشكل المشاركة في الجمال و يركز بحثه حول أصل التمثل. فأن نقول إن الجمال هو التمثل الجميل لشيء ما هو أن نعطي للفن خاصية جوهرية باعتباره نشاط مبدع يهدف إلى التمثل الجميل. و إذا كان الفن هو التمثل الجميل لشيء ما فإنه يهدف لإنتاج الجمال الذي يرتبط بالفنان, بأسلوب و بشيطان, وهو ما يؤدي إلى تغير جوهري في فهم التمثل, فليس التمثل مجهود إعادة إنتاج و لكنه مجهود إنتاج, مجهود خلق. و في هذا المعنى يقول برقسون:" يهدف الفن دائما لان يطبع فينا أحاسيس أكثر من التعبير عنها". و من هذا المنطلق يرتبط الفن بالأثر الجميل و التمثل يمكن أن يفيد عندها التصوير الواعي لما هو خارجي أو لما هو داخلي, و في كلتا الحالتين فان حقيقته هي الذاتية المبدعة.
الجمال هو، إذن، ما هو جميل داخليا أي أن الفن يعبر عمن يكابد ذاته خارج كل مسافة وبالتالي عمن يكابد ذاته مباشرة, و التمثل الجميل ليس رسما للمرئي و لكنه تعبير عن اللامرئي, عن الداخلية وعما لا يمكن رؤيته. و هذا يعني أن ذاتية الفنان هو المكان الذي تتحقق و تتمظهر فيه حقيقة الفن، ذلك أن محتوى و شكل الأثر من مشمولات الذاتية المتحررة من إجبار تمثل طبيعة مادية ميتة سابقة في الوجود على الذاتية و تملي عليها المحتوى و الشكل فتقتل بهذه الكيفية الجمال.
هذا يعني أن الجمال لا يرافق التمثل إلا بفضل أسلوب الفنان, و التمثل يكون جميلا عندما يصبح تعبيرا. و بالتالي فان الجمال هو شكل محدد من قبل محتوى غير مرئي. يتعلق الأمر إذن بالاعتراف بالفنان كقادر على نشاط تتوجه فيه حريته نحو حقيقة عالم جديد يتمثل فيه بحثه عن اللامتناهي, عالم تكون داخليته فيه علامة التسديد, يقول هنري دولاكروا :" للفن دائما وظيفة خلق عالم يكون فيه الفكر في بيته".
الجمال إذن ليس مجال القاعدة و لكن مجال الأفكار تماما مثلما عبر عن ذلك هيجل عندما اقر :" يتحدد الجمال كتمظهر محسوس للفكرة ", فالجمال لا غاية له فالأثر الجميل هو غاية ذاته, هو رمز التناغم الذي لا يتحقق في الإنسانية إلا بالحرية المتقاسمة. وهو ما يعني إن الفنان هو المبدع الذي يظهر عالم الإمكانات الذي يحمله في ذاته, عالم الحياة, عالم من يكابد ذاته و يعطي شكلا للحياة عبر إنتاج اثر حي حيث يقول لافيل:" إن ما يخصّ الفن هو أن يعطي شكلا لعالم الإمكانات هذا الذي نحمله في أعماق وعينا ". إن الفنان لا ينسخ الطبيعة مثلما علمنا هيجل, انه لا يتخلى عن شيء لان الذات لا تستطيع أن تنفصل عن ذاتها, انه يهب الحياة بإبداعه للجمال.
3) الخلق الفني ومشكل الإلهام
إذا كان الأثر الفني هو المجموع المنظم من العلامات والمواد في شكل يضعه ذهن خلاّق, مجموع ينتج فينا جماله انشراحا لامصلحيّا، ففيما يتمثل خلق هذا الأثر الذي نحدّده باعتباره الماهية الروحية للأشياء ؟
يرى أفلاطون أن الخلق الفني ناتج عن الهام الآلهة أو الجن، إذ يرى أن الشاعر يخلق بفضل موهبة ربانية. و وفق هذا المنظور يبدو أن للفنان امتياز ملغز , فالوحي الإلهي هو الذي يدفعه للتأليف أو الرسم دون أن تكون له القدرة على ذلك. قول أفلاطون: «إن الشاعر لا يكون في حالة خلق قبل أن يكون ملهما من الآلهة ».
كانط أيضا يطرح مسألة الشيطان الطبيعي. فالشيطان موهبة طبيعية تعطي قواعد للفن، هو استعداد فطري للذهن يقول كانط:«الشيطان هو الموهبة التي تمكّن الفن من قواعده».
أما كارل قيستاف يانغ يعتبر، مفسّرا ما يسميه البعض بالإلهام، أن الفنان كالأداة في يد اللاشعور الجمعي. غير أن هيجل يذهب أبعد من ذلك و يدحض نظرية الإلهام، إذ يرى أن الخلق الفني هو ضرب من ضروب التفكير ولكن تفكيرا لا يستند إلى المفاهيم بل إلى الأشكال والخطوط والألوان .
ذلك أن كل تفكير بالنسبة لهيجل يعني إنتاج أفكار، و رغم كون الفكرة يمكن تمثلها بطرق مختلفة فان وجود فكر يعني وجود تفكير، عمل ثقافي ومفهومي. إلا أن التفكير الفلسفي تفكير خاص: فالفيلسوف هو الشخص الذي يأخذ الفكر المحض كموضوع، لكن هذا لا يعني أن الفيلسوف يبقى في التجريد المحض و الفارغ على غرار الريبي، ولكن يعني أن تفكيره ليس ترجمة مباشرة أو إعادة إنتاج للواقع، فأن نفكر فلسفيا هو أن نفكر بالكيفية التي تجعلنا نجد تدريجيا محتوى التفكير عبر أنماط ووسائط, مراحل وسطية تثري الفكر وتوضح الفكرة.
والفيلسوف من هذا المنطلق هو الذي يظهر لنا الفكرة في شكل ما، بخطابه وبنظريته. وهذا الشكل هو الشكل الفلسفي الاستدلالي. ذلك أن اللغة المفهومية هي أداة الفيلسوف، تماما كما تمثل الريشة والألوان أدوات للرسام. فالفكرة يمكن أن تقدم في أنماط مختلفة باختلاف ضروب الفكر الذي ينتجها ويظهرها، ففي حين أن فكرة السلم يقدمها الفنان في شكل رمزي، "حمامة بيضاء"، مثل ما هو الشأن مع بيكاسو مثل, فإنها تتخذ من الخطاب الفلسفي شكلا نظريا و مفهوميا في تناقضها مع فكرة الحرب. وهكذا يستطيع هيقل أن ينقد الفنان الذي يأخذ عن الفيلسوف طريقته المميزة في التفكير، لأنه في هذه الحالة، لن ينتج أثرا فنيا ولكن انتحالا لفكر فلسفي، و عوض أن يعبر عن الفكرة التي يريد إظهارها في شكل فني, يقدمها في شكل شبه فكرة فلسفية. فعندما يحاكي الفنان الفيلسوف يكون إنتاجه مناقضا للأثر الفني لأنه لا يحترم خصوصية وأصالة ضرب الفكر الفني . ولكن فيما تتمثل هذه الخصوصية بالنسبة لهيقل؟
إن العنصر الأساسي الذي يميز ضرب التفكير الفني على التفكير الفلسفي, هو الخيال. والخيال بالنسبة لهيقل ليس خاصية فلسفية فهو ليس جوهريا في إنتاج الأفكار الفلسفية، في حين أنه يمثل الأداة الأساسية والمفضلة بالنسبة للفنان عند تعبيره عن الواقع. لكن يجب أن نلاحظ أنه إذا كان الخيال يحقق للفنان أصالة منظوره, فإنه يصنع في نفس الوقت بعض الحدود. فبخياله, يصل الفنان مباشرة و دون واسطة إلى"علة و ماهية الأشياء" أي أن الخيال يمكّنه من استكناه عمق ومعنى الأشياء عبر الصور وأشكال والتمثيل. و عوض أن يحصل على هذه المعرفة، على طريقة الفيلسوف, أي انطلاقا من مبدأ ما أو من تصور عام، يرى الفنان، بفضل الخيال, الأشياء في صورة حسية, في واقع فردي, ومن هذا المنطلق تكون الطريقة التي يتمثل بها الفنان الأشياء دائما أكثر ذاتية, أكثر فردية, وبالتالي محدودة أكثر من طريقة الفيلسوف، فهذا الأخير يذهب بأقل سرعة نحو ماهية الشيء بما أنه في حاجة لكي يظهرها لنا في شكل فكرة, إلى عمل مفهومي طويل يتضمن عدة وسائط, و تكون حقيقة تمثلا ته أكثر كونية من تمثلات الفنان.
الخلق الفني ينشأ،إذن، عن دور الخيال و عن طبيعة الأشكال المُفَكَّر فيها التي ينتجها الخيال، لكن ما يريد الفنان التعبير عنه هو كل «ما يتحرك ويتخمر في خاطره»، وهيقل يقدم من خلال هذه الصورة فكرة حركة تهز أفكار الفنان في داخليته، وإنه لفي هذه الداخلية شبه المبهمة لذهنه أين تهتز، تعتمل و تتخمر الأفكار, دون أن نستطيع تصوّر مأتاها و لا كيف يستطيع الفنان إخراج هذه الحياة الداخلية. المشكل هو إذن مشكل تمثل , الفنان عليه أن يتمثل هذا العالم الداخلي الذي يهزه في نفس الوقت الذي عليه فيه أن يوجد أشكال تمثلها للآخر عبر الأثر الفني. عليه إذن أن يترجم في أشكال حسية الأفكار التي توجد في ذهنه، وهنا بالذات يتدخل خياله. فالفنان هو ذاك الذي يُجَمَّع بإدراك حاد وحدّة الصور والمظاهر الحسية التي يقدّمها له الواقع الخارجي، فيخزّنها, و يمتلكها حتى يستطيع فيم بعد استثمارها ليعطي شكلا لأفكاره الخاصة. و هذه القدرة المميزة للفنان تمثل، في نفس الوقت, حدا له, إذ أنه لا يستطيع مثلا أن يعطيها شكلا مفهوميا مثل الفيلسوف. و مع ذلك فإن هذه الترجمة للفكرة الداخلية في شكل المظاهر الحسية ليس عملا ميكانيكيا بسيطا, إنها تفترض عمل الفنان، عمل مطابقة و ملاءمة، بالكيفية التي تجعل الأشكال تُطوَّع وتخضع للهدف، أي التعبير عن الفكرة. فليس الشكل في ذاته ولذاته الذي يحدد الأثر الفني : إنه العمل الذي بموجبه تجد الفكرة شكلها، و ليس أي شكل بل الشكل المعبر عن الفكرة.
لذلك ليس من باب الصدفة أن يستعمل هيقل أفعال النّحت، صهر و تشكيل، ليصف العمل الذي يجمع فيه الفنان ما هو عقلاني و صوري، فهذا العمل هو عمل ثقافي، بمعنى أنه يحصل في ذهن الفنان ذاته، و يمثّل استباقا للعمل الجمالي واليدوي الذي يعطي الشكل للأثر الفني. فكل أثر فني هو نتيجة عمل يجمع العنصر العقلي (الفكرة ) والشكل الحسي، و الجمال يكمن في قدرة التحكم في الشكل الملائم للفكرة, في خضوع الشكلانيّ للمفهوميّ. فليس هناك جمال استيتيقي للمفهوم المحض تماما مثلما ليس هناك قيمة جمالية للشكل الفارغ من كل فكرة. لذلك كان على الفنان أن يكون له في نفس الوقت ذهنا ناشطا وحسا عميقا, لأن الأثر الفني ينتج عن الجمع بينهما. وهكذا نتبين أن هيقل يلح على أهمية النشاط الذهني والعقلي في الإبداع الفني وهو نشاط لا يؤخذ، في كثير من الأحيان، بعين الاعتبار أو على الأقل، لا يقدر حق قدره, إذ أننا نميل إلى الحكم على جمالية الآثار الفنية انطلاقا من أشكالها رغم أننا نحكم أيضا على بعض الأعمال بكونها صورية فارغة عندما تخلو من هذا البعد العقلي. وهنا بالذات تكمن أهمية المقاربة الهيقلية، فرغم كون ما نلاحظه في الوهلة الأولى في العمل الفني ليست الفكرة التي يعبر عنها الشكل, يمكن أن نقول أن الأثر الفني، بالنسبة لهيقل، يقتضي حضور الفكر من خلال الشكل دون أن تدوس الفكرة الشكل، أي أن نجاح الأثر الفني ينتج عن التوازن الناتج عن العمل الذهني للفنان بين الشكل والمضمون.
من الواضح إذن، أن أسطورة الفنان المُلهم و المبدع لاشعوريا بوحي شبه سحري أو إلهي, هي بالذات ما ينتقدها هيقل, فإذا كان النشاط الذهني ضروريا للإبداع الفني ,إذا كان ذهن الفنان يجب أن يكون لا فقط يقضا بل ناشطا أيضا فإن وهم الحدس المبصر في الحلم من طرف الفنان لا يمكن أن يكون إلا خرافيا. ثم من يصدق هذا الوهم أمام صرامة الإيقاع في أبيات شعر هوميروس، و أمام البحث عن المجازات التي توشّي الأوديسا, من يصدق أن هوميروس أنتج مثل هذه الرائعة الفنية بطريقة لاشعورية أو رغما عنه.
إن الفن ليس عملا عقليا محضا، و لكن الفنان هو دائما مفكر يستعمل عقله وفكره ليختار الأشكال التي يعبر بها عن أفكاره. والفنان الذي لا يتحكم في موضوعه و يترك نفسه لقوة إلهام خلاق, لا يستطيع أن يصيب هدفه. وحتى عندما يترك في الظاهر القواعد الكلاسيكية والصورية للخلق الإنشائي, يبقى الفنان سيد الأشكال التي يفرضها على الفكر, فالمعرّي ألزم نفسه بما لا يلزم في اللزوميات , لكن إبداعاته لم تكن حرة وفوضوية بل إن الحرية الظاهرة التي مارسها جعلت من الممارسة الفعلية والمتواصلة لعقله أكثر ضرورة.
إن هيقل هو أحد أهم الفلاسفة الذين حاولوا فهم وتفسير ميكانيزمات الإبداع الفني في تفكيره حول الجماليات. و يرفض بقوة الأحكام التي تختزل الإبداع في الإلهام فالفنان لا يقدم ميكانيكيا إلهاما, ولكن في نفس الوقت الذي يؤكد فيه على أهمية العمل الذهني للفنان, يرفض اختزال الفن في الفلسفة يرفض المماهاة بين الإبداع الفني و الإبداع المفهومي.
III الفن و المنفعة
توجد في كل المجتمعات و الدول العصرية هياكل تهتم بالفنون الجميلة، وهي هياكل ترتبط عموما بالمسألة الثقافية، مما يتضمن تحديد الإبداع الفني باعتباره عملا ثقافيا يتسم بالجدية و يرسي قيم جمالية أصيلة تليق بالإنسان من حيث هو كائن ينتج وجوده لذاته. غير أن بعض المواقف البراقماتية لا ترى في الفنون الجميلة إلا مجالا لإنتاج آثار نافعة، و بالتالي تكون غاية الأثر الفني مرطبة بالمصلحة. فكيف تتحدد قيمة الأثر الفني؟ هل تتحدد بالمنفعة المادية أم بما أراد الفنان أن يعبر عنه من تمثلات روحية لا مصلحية؟ و إلى أي مدى يمكن أن تحدد المصلحة جمالية الأثر الفني؟ ثم كيف يمكن أن نقيم الأثر الفني حتى نرد الاعتبار للفن في عصر غدى فيه الفن سجين العلاقات الاقتصادية؟
لا غروي أن الإقرار بأن قيمة العمل الفني تقاس بمدى منفعته، هو إقرار يتضمن أن الفن نافع، أي إن الفن وسيلة لتحقيق غاية خارجة عنه. فالفن، من هذا المنظور، ينتج أشياء يكون استعمالها مفيدا، إذ يهدف الفن إلى المفيد، و كل أثر فني تكون له بالضرورة قيمة استعمالية، غاية أُبدع من أجلها. فيتحدد الجميل تبعا لذلك بالنفع، فالجمال غير النافع هو قبح. و من هنا تبرز نفعية أو برقماتية الفن، و هذه النظرة البراقماتية تجعل من الأثر الفني قريبا من إنتاجات التقنية.
كذلك هو الشأن عند اليونانيين القدامى الذين كانوا يجمعون دائما الفن و النافع، الفن و المستحب. فالأثر الفني عندهم يقوم بوظيفة، و الجميل هو النافع. و يبدو، في إطار هذه الرؤية للفن، أن الأثر الفني يشبع حاجة ما، فهو وسيلة لتحقيق غاية، و التمثال الجميل مفيد لأنه يمكن إحساسنا من التفتق و بالتالي يمكننا من الحصول على رغد ما. و وفق هذا التصور يكون الفن ناجعا، إذ يهدف إلى إشباع عملي، فهو يشبع بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة حجاتنا، و السؤال الأساسي الذي علينا طرحه أمام أثر فني هو : «لما يصلح هذا الأثر؟». و أفلاطون في محاورة «هيبياس الأكبر» يقدم تعريفا ـ سينفيه فيما بعد ـ للجميل يربط فيه الجمال و النفع، و هو تعريف السفسطائي هيبياس الذي يقول :«نحن نسمي أعينا جميلة لا تلك التي لا ترى شيئا و لكن تلك التي ترى و تصلح لهذه الغاية». و هذا يعني أن القبيح هو ما لا يصلح لشيء.
ذلك هو موقف القدامى، و لكن يجب أن نلاحظ أن الجماليات المعاصرة تنحى أيضا نحو هذا الاتجاه، فالكرسي أو الأريكة الحديثة هي مواصلة للتقنية، و الجمالي في البيئة الإنسانية اليوم، بدءا بالأدوات الرائجة الاستعمال و انتهاء بتنظيم المدن ينحى إلى الوظيفي، النافع و الملائم. و الجماليات الصناعية المطبقة في البحث عن الأشكال الجديدة الملائمة لوظائف المنتوجات تلتقي بالتصور اليوناني القديم، فالجمالية الوظيفية المعاصرة تستعيد الفكرة اليونانية التي تقر أن النافع هو جوهر الأثر الفني. لكن هل يمكن فعلا أن نماهي بين الأثر الفني و المنتوجات التقنية؟ بين الفن و ما هو نافع؟
إن من يتأمل لوحة فنية يعلم جيّدا أن السؤال «لما تصلح هذه اللوحة؟» هو سؤال لا معنى له في التجربة الجمالية، إذ كيف يمكن أن يكون الأثر الفني وسيلة لبلوغ غاية؟ واقعا يكون استعماله مفيدا؟ هل أن الفن يهدف جوهريا إلى الوظيفي؟ كيف يمكن لانشراح نزيه، يدقق كانط، أن يكون في علاقة مع النافع؟ كيف يمكن أن نماهي الآثار الفنية بالإنتاجات التقنية التي هي نافعة بالماهية بما أنها تقتضي تطبيق معرفة في إنتاج خيرات مادية؟
في الواقع، تقتضي هذه الأسئلة الاستنكارية بأن الفن لا يمكن أن يرتبط بالمنفعة المادية، و عندما نخرج عن الزاوية البراقماتية يبدو أن النافع ليس له قيمة، بل أكثر من ذلك، يبدو النافع قبيح مثلما يذهب إلى ذلك الروائي الأنقليزي أوسكار وايلد في كتابه «نوايا»، فبعيدا عن إبتذالية الحياة اليومية ينتج الفن نشاطا ثمينا و لامصلحيا، ذلك أن الأثر الفني ينتزعني من عالمي الخاص و الضيق، عالم المنفعة والمصلحة و الحاجات اليومية المبتذلة، و ينعشني إذ يزج بي في عالم آخر، حتى و إن كان هذا العالم من وحي الخيال. فالأثر الفني لا يمدني بالنافع و المستحب بل عكس ذلك ينتزعني منه مثلما أقر ذلك أفلاطون في المحاورة المذكورة أعلاه عندما قال ردا على تحديد السفسطائي هيبياس للجميل :«إن القدر الجميل و الملعقة الجميلة تمكنني من مشاهدة الجمال في ذاته»، و الجمال الفني من هذا المنظور يتعالى على الوظيفة المبتذلة، و الأثر الفني لا يبدو صالحا لشيء مادي مباشر، إذ هو عمل ثقافي يمكننا من التعبير عما هو سامي في الإنسان، إذ هو «تعبير عن تمثلات الروح» يقول هيقل، و بالتالي تتحدد جماليته بالمطابقة بين الشكل المحسوس و المضمون الروحي، مطابقة تقتضي ضربا من التفكير يكون الخيال وسيلته الجوهرية. و مثل هذا النشاط السامي لا يمكن أن يرتبط بمصلحة مادية. و كانط يذهب إلى أبعد من ذلك عندما أقر في القرن الثامن عشر بأن الفن لا يمكن أن يكون وسيلة و إنما هو غاية في حد ذاته، ذلك أن الجميل في المنظور الكانطي هو موضوع حكم ذوقي نزيه، و لا نستطيع وفق هذا التصور أن نربط الفن بالنافع أو بالمصلحة العملية. و هذا يعني أن الجميل في الأثر الفني يبعدنا عن كل إشباع خبري أو مصلحي، خاصة و أن كانط كان له الفضل في التمييز بين ما يروق للحواس، أي ما يمكن أن يكون نافعا لحواسنا و هو المستحب و بين الإحساس النزيه بالإشراح الذي يمثله الجميل. فكيف يمكن للأثر الفني أن يكون نافعا في حين أنه لا يفتننا بطريقة محسوسة بما أنه يجرنا بعيدا عن العالم و يحررنا من إمبريالية رغباتنا الحسية؟ غير أن نقد الموقف البراقماتي الذي يربط بين الأثر الفني و المصلحة من قبل الموقف المثالي الذي يعتبر الفن غاية في حد ذاته، يبدو نقدا مغاليا. فهل أن النافع هو فقط وسيلة لتحقيق غاية ما؟ ألا يمكن أن يوجد نفع أوسع وأعمق من النفعية المادية الضيقة؟
هذا يعني أنه لا يمكننا أن نختزل النفع في الربح المادي فقط، إذ يمكن أن يعني النافع في معنى ثان ما هو قادر على تحقيق سعادة الإنسان. و النافع من هذا المنطلق يمكن أن يكون الكيفية التي أحقق بها الانشراح و السرور، و يكون الفن بمثابة الوعد بالسعادة. و بالتالي في ما عدى النفع المادي المباشر، يوجد نفع وجودي أعمق و أشمل، و لا يكون النافع من هذا المنظور وسيلة مرتبطة بتحقيق نتيجة ما ولكن نشاطا مرفوقا بالانشراح، نشاطا يثري الوجود الإنساني و يمكّن الفنان كما المستهلك من التفتق الروحي. ففي هذا المستوى و على عكس المنتظر تكون النزاهة ذاتها مصدرا للسعادة و الخلود، و الفن الذي هو ثمرة نشاط لا غاية عملية له يكون نافعا بما أنه ينتج قيما نوعية، فيكون الأثر الفني، في نفس الوقت، جميل و خير و نافع لأنه يسهم في سعادة الإنسان و تروحنه.
و هكذا نتبين أن تقييم الأثر الفني بنفعه يؤدي إلى تهميش البعد الثقافي للعمل الفني و ينزل به إلى مستوى الابتذال الذي من المفروض أن يحررنا منه. لكن رغم ذلك لا يمكن أن ننفي كل نفع على الآثار الفنية، إذ يبدو الإبداع الفني كالوعد بالسعادة و التروحن و يحقق بالتالي نفعا روحيا يخلصنا من الموقف المثالي الذي يعتبر الفن غاية في حد ذاته، ذلك أن مقولة «الفن للفن» هي مقولة صورية و جوفاء لا تخدم الفن بقدر ما تؤدي إلى نخبويته.
IV الفن والرغبة:
يسعى فرويد إلى فهم الفن انطلاقا من الرغبة، إذ يبدو أن الرغبة باعتبارها الميل الذي يدفع الإنسان إلى تحطيم الموضوع والتضحية به في سبيل إشباع ذاتي, هي الحد الذي يمكّننا من فهم الجمال الفني, أليس الجميل هو ما أرغب فيه وأود امتلاكه؟ لكن هذه النظرة للفن خاطئة باعتراف فرويد نفسه، بما أنها لا تُعلمنا شيئا عن الفن وإنما فقط عن شخصية الفنان. ثم إذا كان تمثّل جسد عار يوقظ فينا رغبة جنسية فهذا يعني أننا لا ننظر إلى اللوحة في بعدها الجمالي، ذلك أن الجمال الفني لا يهب نفسه لرغباتنا ولا يتعلق إلا بالجانب النظري للذهن الذي يُبقي على موضوعه في حريته. و هذا يعني أن علاقة الإنسان بالآثار الفنية والجميل ليست من باب الرغبة، لأن الأثر الفني يحرّرنا من الرغبة الحسية ويوصلنا أبعد من ذلك، إلي انشراح لا مصلحي وتأملي صرف مثلما ذهب إلى ذلك كانط، فتحديد الفن انطلاقا من المحسوس والرغبة هو تحديد منقوص، فالفن هو الذهن الذي يأخذ ذاته كموضوع إذ يمثل خلق واقع جديد و روحي ويستخرج الحقيقة العميقة من المظاهر الحسية ويعبر عنها. وهيجل يقدم لنا مثال التماثيل الإغريقية إذ أن الفن الهيلنستي عنده يجعل الشكل الإنساني أكثر كمالا إذ يبعث فيه الحياة ويروحنه وما نراه في الفن الكلاسيكي بصفة عامة هو الروح بكامله , كمكون لعمق الأثر الفني، وأندري مارلو هو أيضا، يرى في الفن خلقا لواقع روحي جديد, إبداعا للإشكال يقول:«الفنانون الكبار ليسو محاكين للعالم بل منافسوه» كذلك الشأن مع بول كلي الذي يقول :«إن الفن لا ينتج ما هو مرئي بل هو ما يجعل الأشياء مرئية».
نستطيع إذن أن نرى في الجميل الفني تعبيرا محسوسا للفكر، فالجميل يتحدد باعتباره التمظهر المحسوس والإمبريقي للفكر, للعنصر الأرقى للفكر والكيان, فالجميل هو وحدة للشكل المحسوس والفكرة الكونية يقول هيجل:« عندما تبقى الفكرة متّحدة و مماهية لمظهرها الخارجي فإن الفكرة لا تكون فقط صادقة ولكن جميلة , فالجميل هو التمظهر المحسوس للفكر» .